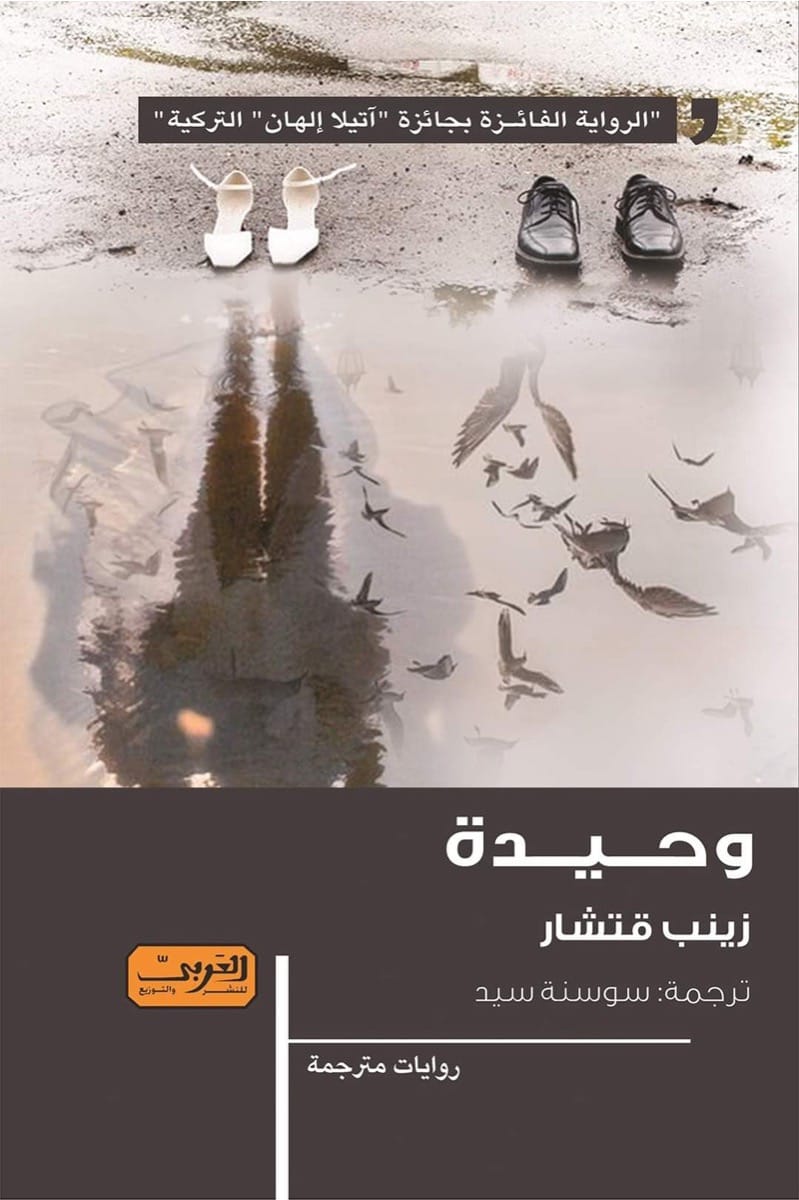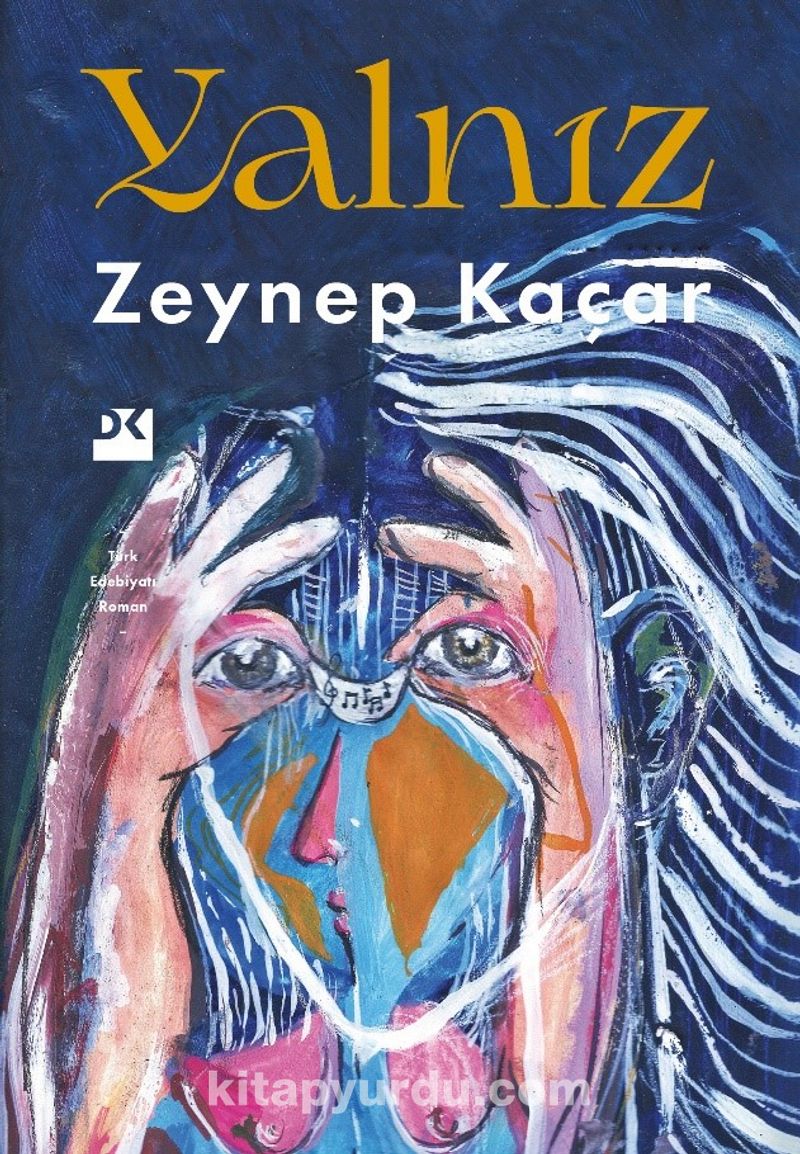الروائية التركية زينب قتشار (دار العربي)
على رغم مما حظي به بعض الادباء الأتراك، من شهرة واسعة في العالم العربي، مثل باموق الحاصل على جائزة نوبل في الأدب إضافة إلى أسماء أخرى، مثل اليف شافاق، ناظم حكمت، وعزيز نسين، فإن حركة الترجمة من التركية إلى العربية، لا يزال يمكن وصفها بالمحدودة، وإن كان انفتاح تركيا في السنوات الأخيرة على الجوار العربي، أسهم بشكل مباشر، في تزايد ملحوظ لنشاط الترجمة من آدابها إلى العربية. وربما كانت الرغبة المتزايدة من قبل الجمهور العربي، لاكتشاف المجتمع التركي، لا سيما في ظل الروابط، والصلات الثقافية القديمة والمشتركة، إضافة إلى ما يتسم به هذا المجتمع، من تنوع شديد، يبلغ أحياناً حد التناقض، دافعاً آخر للاهتمام بالترجمة، بخاصة أن هناك من الأعمال الأدبية المعاصرة، ما جسد انعكاساً حقيقياً وصادقاً له. رواية “وحيدة” الحائزة جائزة “أتيلا إلهان” عام 2022 للكاتبة التركية زينب قتشار، والصادرة، أخيراً، عن دار “العربي” في القاهرة، بترجمة سوسنة سيد، تعد تجلياً لهذا الانعكاس، إذ تحفر بعيداً في تناقضات الواقع التركي، ومشكلاته. وتنكأ جروحاً، لا تنفصل بحال من الأحول، عن واقع عديد من المجتمعات العربية.
جريمة قتل
اعتمدت الكاتبة سرداً ذاتياً، منحت بطلتها “فاراي” صوته، ومكنتها من قيادة دفته. تبدأ الأحداث بقتل البطلة لزوجها صعقاً بالكهرباء، ثم إذابته بالأحماض الكيماوية. وهكذا ضمنت قتشار عبر الاستباق بالجريمة، الدفع بجرعة مكثفة من التشويق، لم ينل منها الكشف عن الجاني والضحية، منذ اللحظة الأولى للسرد، إذ أبقت دوافع القتل خفية، لتتكشف تباعاً مع توالي الأحداث، التي تدفقت في خطين زمنيين متوازيين. يستعيد السرد عبر الخط الأول ثلاثة عقود سبقت القتل، وقادت إليه، في حين انطلق في الخط الثاني، من اللحظة التي تلت الجريمة الأولى، والتي قادت لجرائم أخرى. وبادلت الكاتبة بين الزمنين، “الحاضر والماضي”، مستخدمة تقنية التقطيع السينمائي، فمنحت السرد سمة بصرية.
وأتاح لها اتساع الفضاء الزمني للأحداث، إمكانية رصد خصائص المجتمع التركي، منذ مطلع حقبة التسعينيات، وحتى نهاية العقد الثاني من الألفية الثالثة. وتوثيق كل ما لحق به من تحولات ثقافية، واجتماعية خطرة، ألقت بظلالها على الشخوص. فالشابة الجامحة “فاراي”، التي كانت تحلم أن تصبح مغنية روك شهيرة، تغيرت وجهة أحلامها نحو الفيزياء، لكنها بمرور الوقت فقدت كل أحلامها دفعة واحدة. وفقدت كذلك نفسها وابنتها وحريتها وغدت حبيسة صندوق في غرفة لا تبرحها، هذا التحول لم تختره “فاراي”، وإنما فرضه زوج، أصابته اللعنة نفسها، فقد تحول من طبيب واعد، إلى مدلس بعنوان (شيخ طريقة)، “يقول إنه يفعل ما يعجز عنه الطب! سأجن. متى فقد هذا الرجل عقله، لدرجة أن يظن نفسه رسولاً، لأنه باع لعدة مجاذيب –حسناً، أقصد لعدة أشخاص يائسين- علاجاً على أنه ماء مبارك؟” ص 119. وكما رصدت الكاتبة تحولات لحقت بشخوصها، تتبعت ما طرأ على الفضاء المكاني للسرد الموزع بين مدينتي بورصة وإسطنبول، من تغيرات. وتمكنت عبر كل ما رصدته، من توثيق بعض تحولات الثقافة التركية، في الألفية الثالثة.
الوحدة وتبعاتها
يبرز البعد السيكولوجي والاجتماعي كمكونين رئيسين، في رسم الكاتبة لشخوصها. فالوحدة التي عاشتها البطلة، في مختلف مراحل حياتها، بداية من طفولتها، التي قضتها في مدرسة داخلية، بعيداً من أبويها، جعلتها أكثر تعطشاً واحتياجاً للوجود داخل محيط اجتماعي، وأن تراها عيون الآخرين، ما برر شعورها العميق بالخذلان، حين غابت صديقتها. وفسر ما آلت إليه من هشاشة، ترتب عليها وقوعها سريعاً، في شرك رجل ظنت أنها تحبه، لتنزلق عبر هذا الحب إلى هاوية جديدة من الوحدة، مع زوج لا يشعر، ولا يبالي، ولا يشارك، ولا يدعم. وإنما يطوع الدين وفق هواه، ليمارس الفوقية والغطرسة إزاء النساء، باعتبارهن حلقة اجتماعية أضعف. ونتيجة كل ما تعرضت له البطلة من قهر وتهميش، غاصت في بئر سحيقة.
وباتت تشعر أنها “غير مرئية”، وهي العبارة التي كررتها الكاتبة، في غير موضع من النسيج، للدلالة على عمق أزمة الشخصية المحورية، وتعقيدها، حد اعتيادها ذلك الشعور… “اعتدت إلى حد كبير على كوني غير مرئية. يشعرك هذا الأمر بحرية غريبة، فبإمكانك أن تحدق بلا خجل في أي مما تشعر بالفضول نحوه، لم يعد هناك داع للألاعيب” ص 61. ولم تكن هذه الوحدة سمة البطلة وحدها، وإنما كانت ثيمة، تشاركتها كل الشخوص النسائية في النص. وكانت دائماً أصل الشرور، فكان الموت قتلاً نصيب اليتيمات، ما دام لا يعرفهن أحد. وحتى “حواء”، غريمة البطلة، كانت وحدتها سبباً أصيلاً في إيذائها زوجة أخيها، واستيلائها على ابنتها. كذلك أبرزت قتشار الأبعاد النفسية، والاجتماعية لشخصية “ولي”، وأضاءت معطيات ومقدمات التحول، الذي لحق به. فالشاب الذي نشأ يتيماً، فقيراً، في بيئة تحوي بذور التشدد الديني، كان أكثر قابلية للسقوط في فخ الوهم، وتصور نفسه مبعوثاً من الله، واستخدام معرفته الطبية لخداع اليائسين، واستغلالهم، وإقناعهم بامتلاكه قدرات خارقة.
وجهت الكاتبة سهام النقد، إلى فئة تستخدم الدين في تغييب العقول واستغلال الجماهير، مستفيدة من سطوة الوازع الديني لديهم، واستعدادهم الفطري لقبول كل ما هو غيبي، ويستعصي على المنطق والتفسير. وأظهرت العطب الضارب في شخصية “ولي”، لتبين قدر التدليس، والكذب والنفاق الديني، لدى تلك الفئة. فالرجل الذي يبدو للعالم صالحاً، وصاحب كرامات، يستخدم خادمه لسرقة المورفين من المستشفيات. ويعطيه لمريديه من دون علمهم. وينتهك زوجة ذاك الخادم، عبر إقناعها أنه يفعل ذلك من منطلق ديني، كي يساعدها على الإنجاب، بهدف المحافظة على زواجها من الانهيار! ولا يتوانى في إيذاء زوجته، وانتزاع ابنتها منها وسرقة ميراثها وامتهان إنسانيتها، فضلاً عن مشاركة شيخه في الاتجار بالنساء، والمخدرات. وبينت قتشار عبر كل ما ساقته خطورة تلك الفئة، على النساء خاصة، وعلى المجتمع بوجه عام، لقدرتهم على ترويج الأكاذيب -باسم الدين- وجر المجتمعات سنوات ضوئية إلى الوراء: “لم يكن بلوغها سهلاً حياة الرفاهية هذه، بل أسستموها على جثث النساء، رؤوسكم مرفوعة، وطريقكم طريق الله، وقلوبكم عامرة بالإيمان، فمن قد يضيره تزييفكم للدين بعض الشيء، أليس هذا ما تظنونه؟ أحدكما يظن نفسه نبياً، والأخرى لا أعلم من تظن نفسها؟” ص 223.
كذلك لجأت إلى السخرية، والكوميديا السوداء، لفضح ما تحمله أفكارهم من جهل، وظلامية… “زنديقة مثلي لا يمكن الوثوق بها. فالفتاة قد تحيد عن الطريق القويم، بسبب لحاف اشترته أمها معاذ الله!” ص 199.
في ثنايا ما رصدته قتشار من نفاق ديني، واستثمار الدين، من قبل بعض المدلسين للتكسب، وثقت الأثمان الباهظة، التي تدفعها النساء، في مجتمعات يجد فيها أولئك المدلسون، مهداً خصباً للنمو والانتشار: “جميعنا في عيونهم مكروهات، وكافرات، ويجب قتلنا” ص 194. وساقت من الأحداث ما وثقت عبره فداحة هذه الأثمان. فلم يتورع “ولي” وأتباعه، عن تعذيب زوجاتهم، وقتلهن، بحجة تأديبهن، وإصلاحهن. فلا يسمح الرجل لزوجته بتجاوز باب منزلها، خوفاً من الوقوع في الإثم، لكنه لا يخشى الإثم، حين يعذبها أو يقتلها، إذا خالفت أوامره. وعبر هذه الصور التي ترصد قهراً، لا تواجهه المرأة إلا بالصمت، تراجع الصراع الخارجي، في حين علا صوته في العوالم الداخلية للبطلة، المنقسمة بين الحب والكراهية، الجموح والاستكانة، الرغبة في التمرد، والجنوح إلى الاستسلام، الندم واللامبالاة. وقد منحت الكاتبة فرصة لهذا الصراع، وما يعتمل في عوالم البطلة الداخلية، من مشاعر كثيفة ومعقدة ومتناقضة أحياناً، فرصة الطفو على السطح، عبر تيار الوعي، والمونولوغ. وعززت هذه الغاية، باستخدامها ضمير المتكلم، ومنحها بطلتها صوت السرد: “هذا الرجل الذي أحببته وأحبني، لم يعد موجوداً. لا يوجد أحد يحبني الآن على وجه الأرض. أينما ذهبت، ومهما فعلت. لا أحد. أفتش داخلي عن شعور يشبه الندم، ندمي ميت مثله تقريباً” ص 61. وقد تمكنت عبر ما بثته من مشاعر مكثفة، من إنتاج القلق، الذي يدفع بالقارئ طوعاً للمشاركة في لعبة السرد.
وجوه المدينة
مررت “قتشار” نقداً ضمنياً، لمجتمع يتحول باتجاه المحافظة، عبر ما أبرزته من تماثل بين البطلة، ومدينة إسطنبول. وبينها، وبين شارع “استقلال”. فكما تخلت “فاراي” عن أحلامها، وهويتها، من أجل زوج استلبها، وامتهنها، تخلت المدينة عن أصالتها. وحادت عن هويتها. ورصدت كذلك ما طرأ على المجتمع، من قيم استهلاكية، وانسحاب الناس خلف شاشات الهاتف المحمول، بديلاً عن التواصل في ما بينهم. وعزز كل ما رصدته من تحولات، حالة النوستالجيا للوجه الأقدم من المدينة، وحالة الاغتراب نتيجة وجهها الجديد. ودعمت هذه النوستالجيا، باستدعاء بعض ملامح المدينة التراثية، مثل “الضريح الأخضر”، و”أولو جامع”، كما استدعت أحد أهم رموز الموسيقى الكلاسيكية التركية، زكي موران. وعرجت على بعض المأكولات، والمشروبات الشعبية، مثل مشروب “العيران”. وتطرقت كذلك لبعض العادات الشعبية الغريبة، مثل عادة صفع الفتاة عند بلوغها، لتكشف عبرها، عن جذور امتهان المرأة، في ثقافة المجتمع، التي لا تنفك تنمو، مهما تعاقبت العصور!
ومررت بعض المقاربات، بين مسارات النفس الإنسانية، وقوانين الفيزياء. وجعلت من هذه المقاربات، مدخلاً لحمولات معرفية، زادت من جمالية النص. وعززت عبرها حضور البعد السيكولوجي للسرد، في محاولة لإضاءة خبايا النفس الإنسانية، التي تسعى لتحقيق توازنها في هذا العالم، عبر عديد من الحيل النفسية، مثل الإنكار، التبرير، جلد الذات، العزلة وأحياناً الانتقام.