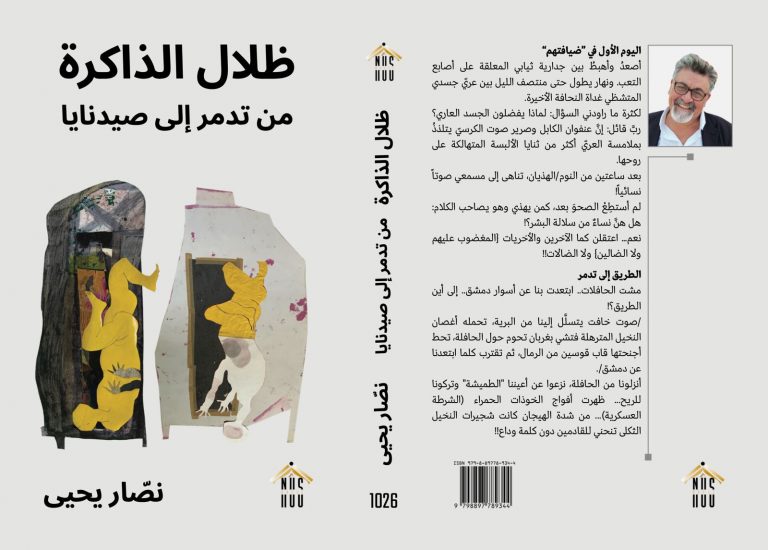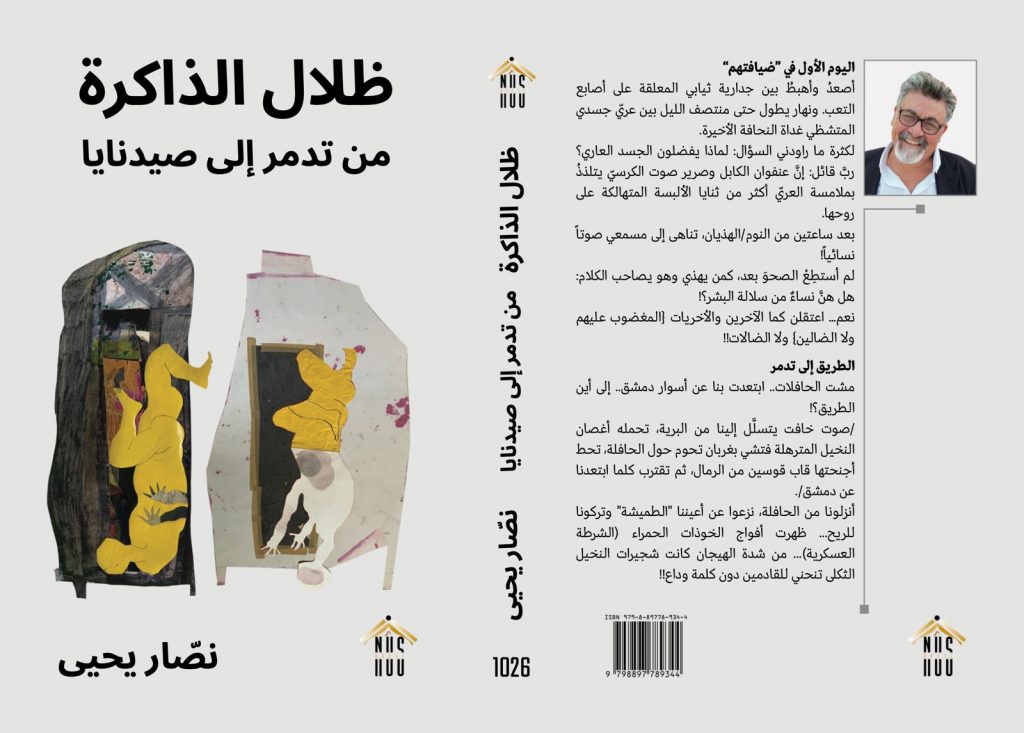
كنت أنتظره مثل طفلي حينما قدما إلى الحياة..
سأضع هنا، استهلال لمحاولة الاصغاء لبعض الشدو والشجن كي يتعانقا مع رنيم ذلك الكلام المكتوب الذي انتقل بكامل اناقته إلى بياض الورق..
أعود واذكر بصديقي الفنان الجميل نسيم الياس صاحب الغلاف، وخالد الخطيب دائما الجندي المجهول الذي استقبل اللوحة نقلها لجهة التصميم النهائية..
وبداهة الشكر موصول لدار النشر نوس هاوس، بادارة الصديق مصطفى والصديقة رودي.
أشكر الكثير من الأصدقاء الذين تفاعلوا معي بحوارية قل مثيلها، أو الذين لم يتفاعلوا لسبب أو لآخر..
علي الكردي، محمد ابراهيم، علي الجندي، منصور منصور، ابراهيم زورو، ليلى العامري، بدر زكريا، محمد كركوز، محمد شاهين أبو حازم، أحمد خليل، خليل حسين، مروان محمد، موفق العائدي، ابراهيم أسعد..
ولاشك أن هناك آخرين واخريات، لم أقصد التجاهل..
استهلال
يسألني القارئ عن تلك الرحلة التي حملت عنوان: ظلال الذاكرة من تدمر إلى صيدنايا.
/كنتُ أقرأ رواية تقرير إلى غريكو للروائي اليوناني نيكوس كازنتزاكيس، لفت انتباهي وقوفه أمامَ عبارة:
“على لسان متصوف: طالما لانستطيع تغيير الواقع، فلنغير العيون التي ترى الواقع”/
ونحن هناك حاولنا تغيير “عيوننا” بالمعنى المجازي من خلال الكتاب.
شتى أنواع الطيف الإبداعي (سياسة، أدب، فلسفة، تاريخ، نقد أدبي وسدرة المنتهى التحليل النفسي).
هل هي سيرة ذاتية؟
هل يمكن اعتبارها مما يطلق عليه أدب السجون؟
هي تحاول محاكاة تجربتنا كتنظيم سياسي يساري معارض لنظام الأسد الاستبدادي في مرحلة خاصة ما بين أول ثمانينيات القرن الماضي وأول التسعينات، يوم الخروج من ذاك النفق (السجن)؛ لم يخرج كل معتقلو الحزب وبقية اليسار السوري (حزب شيوعي-مكتب سياسي وحزب البعث الديمقراطي)، تسلسل الخروج لما بعد وفاة الدكتاتور بتاريخ 10 حزيران عام 2000، حيث بقي البعض لنهاية 2001. بعد استلام الوريث الأبله.
كانت الهواجس تصغي لشفيف الذاكرة: هناك في مكان اسمه سجن تدمر ثم فرع التحقيق العسكري والمحطة الاخيرة في ذلك الملتقى الجبلي، وأطلق عليه: سجن صيدنايا..
ودار حوار بين هسيس الذاكرة وخطاب الكلام: أخرجني من العتمة إلى فضاء الورق الأبيض، أريدُ أن أجدَ نفسي حاضرة بينكم الآن والى أن يدوم الوقت، زائرةٌ لقارئ ينتظر عالم “الخبايا والخفايا” إنه السجن.
وبدأت رحلة الكتابة، عبر عناوين أخذت صيغة الحكايا: بأجزاء متسلسلة حتى ينتهي بها الترحال في الجزء الواحد والعشرين.
كان هناك سياق زمني ابتدأ بالطريق الى سجن تدمر بعد الاعتقال بأربعة أشهر ونصف.
لكن ذلك التعاقب الزمني تخلله عَودٌ على بدء من جديد، حيث يختلي بنفسه الزمن بتناوب المكان بين الداخل (السجن) والخارج مثلاً مدينة دمشق حيث عشت بها قبل الاعتقال لمدة سبع سنوات، منها أربع سنوات، متخفٍ عن أنظار الاجهزة الامنية.
لطالما كان للمكان (السجن) رائحته الخاصة، يتحسسها من عاشها بتفاصيل العلاقة بين العازل والسجان، ثم هذا الجمع البشري الذي وجد نفسه داخل هذا المكان، حيث تتأسس علاقات من نمطٍ “القرابة” الجديد، بعلاقات جديدة مغايرة كلياً لما هو مألوف من نظام العصبيات الطبيعي.
في السجن التقى الجمع على أرضية الانتماء السياسي للحزب الواحد، أو “ابن عمه”، لذلك من الطبيعي أن تظهر مفردات مختلفة عن الحياة العادية المألوفة لأصحابها.
يمضي “أوديسيوس” بطل هوميروس في رحلة العودة بعد الانتصار على الطرواديين، في رحلة التيه والبحث عن المكان المفتقد مدينة إيثاكا. الشاعر اليوناني كفافيس كثف الرحلة بقوله: لولا إيثاكا لما انطلقت تلك الرحلة.
رحلتنا نحن المعتقلين لم نختَرها، فُرضت علينا بتعدد “بيوتاتها” من فرع التحقيق العسكري حيث المبتدى الى صيدنايا مرورا بالتجربة الاقسى سجن تدمر الصحراوي.
وكان من الطبيعي أن يُسأل الحزب عن كل مايفكر به؛ السجن فسحة للتفكير ومساحة للوعي أن تطرح نفسها.
هذه الرحلة (ظلال الذاكرة من تدمر الى صيدنايا)، همستْ ثم غمزت لها التفاصيل..لم يكن هناك (تابوهات)، ولاشك يبقى هناك بعض المسكوت عنه، وهذا من طبيعة الخطاب أو الكلام المكتوب، الذي يلامس حيطان الممنوع والممتنع على التفكير، خاصة خفايا ورغبات الجسد المقموع هناك على صليل شبابيك السجن والسجان.
هل كانت (الحكايا) تنطلق من نرجسيتي الخاصة كوني أنا السارد وأحيانا العليم؟
سأترك ذلك للقارئ المشارك دون مسبّقات، أو منظومة تفكير لاتعترف الا بنفسها، كما المطلق المتعالي خارج الزمان والمكان.
شغلتني أيضا فكرة الحكواتي الراوي، الذي يذهب يقرأ “المرويات والأساطير الشعبية” عبر محاولة محاكاة الحدث بنبر الصورة وايماءات الجسد؛ هو منظر من قبل الجالسين في المكان.
أما الحكواتي الذي دغدغني، انه يكتب عن الحياة هناك بكل تفاصيلها، هو غائب عن المنظور أو الجمهور، يحضر هنا بصفته ضمير غائب كفرد وكمجموع، وأحياناً ضمير متكلم.
قد يجد القارئ بعض التشظي أو الخروج عن السرد بما هو تعبيراً عن مبنى الحكاية، لجهة الاستعارات من خارج السياق، استعارات، معظمها اعتمد التخييل السردي لكن بأسماء كتاب أو فلاسفة أو رجال سياسة حقيقين، ولم يقتصر ذلك على كاتب ما محلي أو عربي ( سعدالله ونوس / مسرحية الفيل يا ملك الزمان).
لطالما رحلة الفلسفة وذبذباتها الوجودية انطلقت من هناك من أوروبا،
سيجد القارئ ذلك لحضور متخيل للكوميديا الإلهية (دانتي) مثلاً، معبد دلفي والفيلسوف سقراط، عداك عن التراجيديا الاغريقية.
كلمة أخيرة
هل استطاع ذلك المكان (السجن) أن يشعرنا بالدفء، أو يجعلنا نرتوي ظمأ “المساكنة الحميمية” معه، حماية لنا من تسلل ذلك “الخارجي” السجان و هوس الوعد والوعيد؟
لنعاودَ التعريف بذلك المكان (السجن):
هو من الخارج محكومٌ بقضبان السجن عبر أبوابٍ معدنية شديدة الصلابة، يتربع عليه السجان “حامي الحمى” بسوط جلدي ينساق بالزمن الى تلك العصور المغرقة في التوحش.
من الداخل: نحن البشر “المعتقلون” إلى أجل لايعرف مصيره إلا الحاكم الاعلى، المتربع على كرسي عرشه.
لكن هؤلاء المعتقلون ينسجون حياة أخرى، تنبني على المفردات الخاصة بها، يُحيكون قصصهم على ضوء فوانيس العتمة.
يذهبون بأحلام يقظتهم إلى عالم رحب، فيه الأحبة وغواليهم، ينسون تلك الجدران الصماء.
وكان الكتاب ..وكانت القراءة خير صديق وجليس.
لتكتمل اللوحة مع العازل:
العازل حيث الغرفة الخاصة التي تستقبل الضيف من عازلٍ مجاور..يتم الترحيب:
لكَ الصدر ولي..ولنا..العتبة..
نصار يحيى