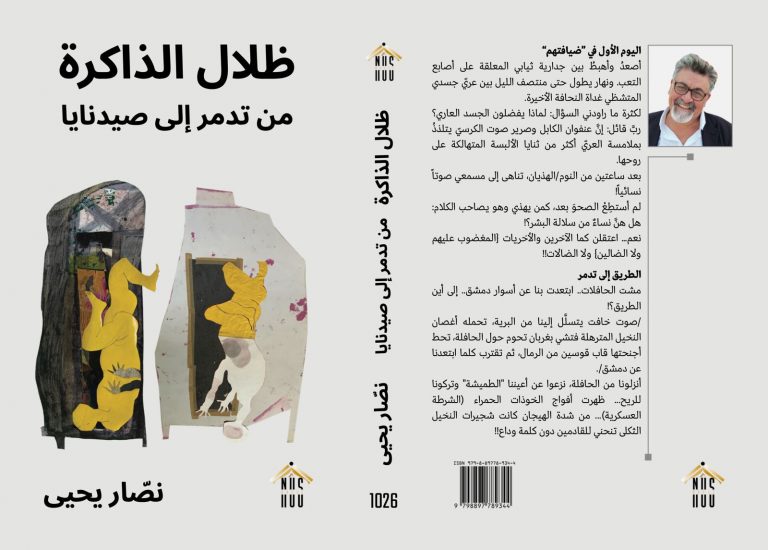عندما تتوقّف السلطة عن أداء وظيفتها الرمزية، لا يعود المجتمع بحاجة إلى مبرّر كي يخرج عن طاعته. الفعل الجماعي لا ينتظر سقوطاً اقتصاديّاً أو تضييقاً سياسيّاً ليظهر، يكفي أن تنكسر العلاقة بين الأفراد واللغة التي تصفهم، بين الحاضر والمخيال الذي يُبرّره. لا تنشأ لحظة التمرّد من غياب العدالة فقط، وإنما من انكشاف العجز عن تمثيل الذات داخل النظام القائم. لم تندلع الاحتجاجات في الفضاء العربي من داخل مشاريع بديلة، ولم تكن نتيجة صراعٍ بين رؤيتين للمجتمع. ظهر التمرّد فجأةً، بلا مقدّمة أيديولوجية، بعد تراكم زمني فقدت خلاله السلطة قدرتها على توليد الإقناع. لم تعد ممكنةً تسمية الأشياء، ولا تبرير الأدوار، ولا إعادة إنتاج الامتثال. هذه لم تكن أزمة نظام سياسي، إنما انهيار في البنية الرمزية التي تنظّم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، بين الفرد والسردية التي منحت هذه الأنظمة مكاناً خلال الحقبة الزمنية التالية لهزيمة حزيران (1967) على أقل تقدير، إن لم نشأ العودة إلى لحظة ولادة الدولة العربية الحديثة ذاتها.
ورغم حدّة الانفجار، لم يحدُث انتقال نحو لغة جديدة. لم يظهر خطاب ثقافي يُعيد تنظيم المعنى، ولم تتشكّل رموزٌ قادرةٌ على حمل القطيعة. ظلّ الفعل حبيس دلالاتٍ موروثة، وظلّ الجسد في الشارع معزولاً عن خيال جمعي يحمله. نشأ فراغ، لا لأن القديم سقط فقط، وإنما لأن الجديد لم يتكوّن. كل شيء تحرّك خارج منظومةٍ قادرةٍ على تأويل ما جرى، ولا نحتاج هنا إلى مراجعة الأسباب المباشرة للاحتجاج لنفهم أين وكيف وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم، إنما إلى تفكيك الشروط التي جعلت التمرّد عاجزاً عن التحوّل. ما انكشف هو انعدام قابلية المجتمع لإنتاج قطيعة رمزية. الجموع خرجت، الهياكل ارتبكت، لكن الثقافة بقيت ثابتةً، كما لو أن الحدث لم يكتب لغته الخاصة، ولم يسائل اللغة التي سبقت. لا يتحوّل التمرّد إلى حدث تاريخي إلا حين يصوغ شكلاً جديداً للانتماء. ما حدث في المنطقة لم ينتج هذا الشكل. الذات التي خرجت لم تعثُر على تمثيل. السلطة ارتبكت، ثم استعادت نفسها بأدوات معدّلة. النظام الرمزي لم يتغيّر، لأن لا أحد كتب اللغة التي يحتاجها كي يتغيّر. الحدث وقع، لكنه لم يؤسِّس. لهذا، يبقى التمرّد معطّلاً.
التمرّد كقيمة لا كأداة: كامو وسوسيولوجيا الرفض المنفصل
لا يُختبر التمرّد داخل التاريخ فقط، بل داخل الوعي الذي يُدرك فجأةً أن استمرار النظام لم يعد نتيجة اقتناع، وأن القبول لم يعد مقايضةً متوازنةً بين الامتثال والنجاة. في هذا الفضاء الرمادي، حيث لا تعود القيم نافعةً، ولا اللغة صالحة للتسمية، يتولّد الفعل التمرّدي، لا كخطة، بل كضرورة.
عند ألبير كامو، التمرّد ليس مشروعاً للخلاص، ولا مرادفاً للثورة. هو حركة رفض ضد العبث، ترفض الانتحار كما ترفض الخضوع. ينهض الإنسان ضد العالم لأنه لم يعد يقبل تفسيراته، لا لأنه يملك تفسيراً آخر. يبدأ التمرد لحظة يتوقّف فيها الإيمان بالمعنى المفروض، من دون أن يحلّ محله معنى بديل. هذا ما يجعل فعل التمرّد، عند كامو، مشبعَاً بالمسؤولية الأخلاقية، لا باليقين الأيديولوجي. تتجلّى هذه الرؤية في شخصية “ميرسو” في رواية “الغريب”. يرفض ميرسو المشاركة في الطقوس الاجتماعية، لا لأنه ناقد لها، بل لأنه لا يرى فيها شيئاً يتصل بحقيقته الداخلية. سلوكه ليس ثورة على نظام سياسي، بقدر ما هو انفصالٌ عن منظومة رمزية فقدت صلاحيتها. يعيش العبث من دون أن ينكره، ويرفض النظام من دون أن يقدّس الفوضى. في هذا الموقف، يكمن قلب التمرّد كما يصوّره كامو: رفضٌ يخلق مسافة، لا اندفاعاً إلى البديل.
خرج الجسد العربي إلى الشارع، لكنه لم يخرج من اللغة التي حبسته
يمكن قراءة لحظة التمرّد العربي الأولى ضمن هذا الإطار: خروج مفاجئ من الامتثال، من دون امتلاك واضح لأفق مختلف. الأصوات في الشارع لم تحمل برنامجاً، بل طرحت رفضاً. لم تكن المطالب مفصّلة، ولم يكن الحلم محدّداً. ظهرت اللغة كما لو أنها وُلدت في أثناء الفعل، لا قبله. سقط الخوف، لا لأن الأمل حلّ مكانه، وإنما لأن الإذعان فقد وجاهته الرمزية. الجموع التي خرجت لم تكن مدفوعةً بنصوص، ولا مدعومةً بسردياتٍ بديلة. ما دفعها كان الشعور بأن ما هو كائنٌ لم يعد ممكناً، من دون أن يتضح ما هو ممكن فعلاً. لا تنتمي هذه البنية التمرّدية إلى الخطاب الثوري التقليدي، لأنّها لا تفترض أيديولوجيا، ولا تُقدّم نفسها بديلاً. إنها لحظة انقطاع، لا لحظة تأسيس. ما يجعل هذه اللحظة ملتبسةً أنّها لم تخرُج من سياق ثقافي يؤهلها لإنتاج خطابها الخاص. في تمرد كامو، هناك تأمل في العبث، وتأصيل أخلاقي للرفض. أما في لحظة الربيع العربي، فقد غاب التأمل، وغاب التأصيل. ظهر التمرّد كضرورة بيولوجية تقريباً، جسدية أكثر منها فكرية، أما الذهن الجمعي فقد بقي من دون أدوات تحليلٍ تواكب ما يجري. أنتج هذا الانفصال بين الفعل والوعي تمرّداً بلا ذاكرة ولا أفق. لم يُكتب هذا التمرّد، ولم يُروَ، ولم تُتح له الثقافة أن يؤسّس لنفسه تاريخاً خاصاً. لم تَصغ له لغة تمنحه بعداً رمزيّاً مستمرّاً. وحين غابت اللغة، بقي التمرّد معلقّاً، مفتوحاً على التأويل، وسهلاً للاحتواء، وهذا ما حصل. وتالياً، تكمن الخطورة في مثل هذا التمرّد في قابليته لأن يُستخدم من دون أن يدرك أنه يُستخدم. رفضٌ لا يحرسه خطاب نقدي، قد يتحوّل بسرعة إلى أداة في يدٍ من يملك قدرة أعلى على اختراع لغةٍ تُناسب الحشود. وحين تصبح هذه اللغة في يد السلطة، يعود التمرّد السابق الذي دفع ثمنه دماء وأرواح لمادة أولية لإعادة إنتاج السلطة، وهذا ما حصل في أكثر من مكان.
ما افتُقد في لحظة الربيع العربي وجود ذاتٍ قادرةٍ على حمل الرفض كقيمة. لا تطلب الذات التي تتمرّد عند كامو تعويضاً، ولا تسعى إلى غنيمة. هي ذاتٌ ترفض، لأن الرفض صار شرط كرامتها. حين تكون الذات مقموعةً ثقافيّاً، بلا مخزون تعبيري، يصبح الفعل التمرّدي محدوداً بمشهديته، ويتحوّل إلى لحظة بصرية قوية لا تملك قابليةً للاستمرار الرمزي. يبدأ تمرّد كامو من العبث، لكنه لا ينتهي فيه. يخلق أخلاقاً جديدة داخل عالم مهدوم. يرفض السلطة، لكنّه يرفض أيضاً العدمية. أما التمرّد العربي، فقد بقي عالقاً بين عالم مرفوض ونقص في القدرة على تخيّل غيره. لم يملك طاقته الرمزية الخاصة، ولم يستطع أن يؤسّس لمنظومةٍ جديدةٍ من القيم، لأن البنية الثقافية التي أفرزته كانت عاجزة عن التحوّل معه. هذه المسافة بين التمرّد والمعنى لا تُردم عبر الخطابة السياسية، ولا تُعالج بالانتقال المؤسّسي وحده. إنها مسافة تنتج عن غياب التخيل الجماعي كقوة تأسيسية. لا يكتفي التمرّد بأن يرفض، بل يحتاج إلى من يكتبه، ويؤرّخه، ويمنحه صفة الفعل المؤسّس. غياب هذا التدوين الرمزي للتمرّد هو ما جعله قابلاً للذوبان، بعدما بدا في لحظته كأنه فتحٌ تاريخي لا رجعة عنه.
الثقافة المضادّة: الجسد كحقل اشتباك رمزي
لا يتحدّد الاحتجاج فقط بمطالبه، وإنما بالمستويات التي يتناولها. حين يقتصر على السياسي، يظلّ قابلاً للاحتواء ضمن منطق الإصلاح أو الردع. لكن حين يمسّ الثقافة، اللغة، الجسد، والمخيال، يتحوّل إلى فعل تفكيك يتجاوز الحدود التنظيمية للمطالبة، ويبدأ في تفتيت البنية التي تستند إليها السلطة في إنتاج الامتثال. هذا هو المستوى الذي بلغته الثقافة المضادّة في لحظات محدّدة من التاريخ الغربي، لا سيما في الستينيات، حيث لم يُطرح التغيير بوصفه انتقالاً وتبديلاً بين أنظمة، وإنما كإعادة تشكيل للعلاقة بين الذات والعالم. التحوّلات التي شهدتها تلك اللحظة لم تنشأ من فراغ. وصل النظام الصناعي إلى حدوده القصوى، تماهت الدولة الحديثة مع الشركات المتغوّلة على المجتمع، وبدأت المؤسّسات التربوية والثقافية تفقد قدرتها على إعادة إنتاج الطبقة الوسطى. ما تصدّع لم يكن فقط نظام السلطة، وإنما الأنساق التي تحدّد ما يُقال، وما يُرغَب فيه، وما يُتخيَّل كـ “حياة ممكنة”. لم يكن ردّ الفعل سياسيّاً صرفاً، ولا متجسّداً في مشاريع بديلة ذات طابع حزبي. ظهر على هيئة لغة جديدة: موسيقى، صورة، مفردات، أداء جسدي في الشوارع، نبرة صوت. ظهرت السياسة في الممارسة اليومية، لا في البيان الأيديولوجي. لم يعد الجسد مفعولاً به، بل أصبح ذاتاً فاعلة تعبّر وتطلب وتنسحب. لم يكن الشارع مجرّد موقع للاحتجاج، بل مسرحاً لإعادة توزيع السلطة الرمزية. ما يُميز تلك الثقافة المضادّة وعيها بأن النظم لا تُنتقد من خارجها فقط، بل من داخل الرموز التي تنتجها. لم يتم الوقوف عند طلب الحقوق، بل جرت مساءلة المفاهيم ذاتها: ما الذي يجعل من الحياة “ناجحة”؟ ما معنى “العمل”؟ من يملك الحقّ في تحديد الأخلاقي واللاأخلاقي؟ كيف يُعاد تعريف الفضاء العام؟ كيف يُقاوَم النظام حين يكون مختبئاً في اللغة، في الهندسة، في الملبس، في النظرة؟
الانفجار الشعبي الذي اجتاح المجال العربي لم يكن مسبوقاً بخطاب نظري يهيّئ الأرض للمعنى، ولم يُتبع بكتابة تاريخية تؤسّسه كمرجع
في المقابل، لم تواكب الانتفاضات العربية أي حركةٍ ثقافيةٍ مضادّة تحمل هذا الوعي الرمزي. التمرّد الذي ظهر كان مكثفاً، جسدياً، مباشراً، لكنه لم ينتج تمثيلاتٍ رمزيةً متماسكةً. بقي مرتبطاً بشعارات متكرّرة، ومفردات مستعارة، وأجساد محاصرة داخل منظوماتٍ أخلاقية مأزومة. لم يتحوّل الجسد إلى موقع إنتاج للمعنى، ولم يخرُج الخطاب من بنيته المحافظة. غاب الأداء، وغابت الصورة، وغابت اللغة القادرة على إنتاج صدمة رمزية. في لحظة الستينيات الأوروبية، لم يكن الشعار ما يحرّك الحشود. كان الشعر، والأغنية، والملصق، والرقص في الفضاءات العامة. كل فعلٍ كان إعادة ترتيب للمعنى، وإعادة توزيع للشرعية. لم تعد السياسة شأناً حزبياً، بل صارت سلوكاً يوميّاً. من هنا جاءت قوة تلك اللحظة، ومن هنا افتقرت لحظة التمرّد العربي إلى الطاقة التأسيسية. الجسد العربي خرج إلى الشارع، لكنه لم يخرج من اللغة التي حبسته. لم تُطرح مفاهيم جديدة للهوية، ولا تحوّلت الذكورة إلى موضوع مساءلة، ولا ظهرت سرديات بديلة للنجاح، للحب، للزمن. بقي التمرّد داخل النمط، ومُنع من تفكيكه. لم يستطع الجسد أن يُعبّر خارج المعجم الموروث، ولم يجد أدواته داخل الثقافة. ظهرت الصرخة، ولم تظهر اللوحة والقصيدة. لم يكن هذا العجز تقنيّاً. لم يكن الأمر مرتبطاً بمستوى التعليم أو عدد الفنانين أو حريات النشر. كان عجزاً رمزيّاً ناتجاً عن انهيار الحقول الثقافية بوصفها وسائط للتأويل. لقد كانت الأنظمة قد استكملت مهمة تدمير كل شيء. الفنون البصرية كانت مشلولةً، المسرح كان مكمّماً، والأدب العربي بكامله كان محاصراً بين الواقعية المهزومة والمجاز الفانتازي. المثقف انفصل عن الشارع، والشارع لم يعد ينتج رموزه الخاصة.
حين يغيب التخييل، لا يستطيع الحدث أن يكتب نفسه. يظلّ مرئيّاً، لكنه بلا أثر. لحظة الستينيات الغربية أنتجت أرشيفاً هائلاً من الصور، والمفاهيم، والسرديات. أما لحظة التمرّد العربي، فقد بقيت بلا أثر. لم تترك بصمة في اللغة، ولا في المشهد، ولا في الشعور العام. حدثت، لكنها لم تُتَخيّل. وكل ما لا يُتخيّل، لا يصير حاضراً، حتى لو وقع. بهذا المعنى، لم تكن أزمة التمرّد في غياب التنظيم، بل في تعذّر التحوّل إلى ثقافة. لم ينشأ داخل الجسد خطاب جديد، ولم تنكسر السلسلة الرمزية التي تنظّم الرغبة والسلطة والهوية. حتى حين تكرّرت صور المواجهة، بقي المعنى داخلها محصوراً، لا ينتج لغة ولا يعدّل الخيال. التحرّر الرمزي لم يحدث. ولهذا السبب، لم يتغيّر شكل الحياة.
ما بعد السردية: التمرّد في زمن التشظي
لا يكفي أن يسقط النظام كي يولد التاريخ. كل قطيعة سياسية تفترض مسبقاً وجود سردية قادرة على تأويلها، وكل تحوّل اجتماعي يحتاج إلى خطاب يشرح، يسرد، ويمنح المعنى. حين يغيب هذا الخطاب، يتحوّل الحدث إلى طيف. يُرى، يُكرّر، يُستعاد، من دون أن يُفهم. ما لا يُفهم لا يتحوّل إلى مؤسّسة، وما لا يُؤسَّس لا يصنع مستقبلاً. هذا ما يجعل مفهوم السردية، كما طرحه مفكرّو ما بعد الحداثة، مفتاحاً لفهم لحظة ما بعد التمرّد العربي. يربط جان فرانسوا ليوتار نهاية السرديات الكبرى بظهور مجتمعاتٍ لم تعد قادرة على تنظيم تجربتها ضمن إطار تأويلي موحّد. في غياب هذه السردية، يتكاثر الكلام، تتداخل الأصوات، وتضيع القدرة على تمييز الحقيقة من المحاكاة. تتفكّك العلاقة بين الحدث وتفسيره، ويصبح الواقع مادّة طيّعة لإعادة التشكيل الرمزي، وفق من يملك السلطة وهو نفسه من يملك أدوات الخطاب.
الانفجار الشعبي الذي اجتاح المجال العربي لم يكن مسبوقاً بخطاب نظري يهيّئ الأرض للمعنى، ولم يُتبع بكتابة تاريخية تؤسّسه كمرجع. بقي معلّقاً بين التسجيل العفوي والتأويل الخارجي. لم تنتجه نخب فكرية تملك قدرة على الصياغة، ولم تتلقّفه مؤسّسات سردية تؤرشفه كفصل من فصول الهوية الجمعية. حتى في لحظة حدوثه، لم يكن متاحاً أمام الذات الجماعية أن تسمّي نفسها أو تحدّد موقعها داخل الزمن. في هذا المناخ، ظهرت صور الحدث من دون حكاية. شعارات متكرّرة، فيديوهات معزولة، مقاطع مبهورة بذاتها، لكن بلا خيط ناظم. الفضاء الإعلامي تحوّل إلى شاشة ضخمة تُبث عليها مشاهد لا يعرف أحد كيف ينظّمها. لا بداية، لا نهاية، لا مركز. فقط تدفّق.
صارت الثورة مجازاً في احتفال رسمي، وصار الشعار زينة لغوية في خطاب بيروقراطي
يصف جان بودريار هذا النمط من التجربة بكونه “واقعاً فائقاً” (hyperreality)، حيث لا يعود الحدث أصلاً، بل يصبح صورةً مكرّرةً لما يُفترض أنه حدث. التمثيل لا يعكس الواقع، وإنما يُخفي غيابه. في هذا المستوى، تصير الثورة نفسها علامةً خاليةً، تُستعمل في خطاب السلطة كما في خطاب المعارضة، من دون أن يكون هناك مضمون محدّد تستند إليه. هذا ما حدث بعد سقوط بعض الأنظمة أو سقوط أجزاء منها. استعارت السلطة الجديدة مفردات الثورة من دون أن تغيّر بنيتها الرمزية. كرّرت المعارضة شعارات قديمة من دون أن تعيد صياغة مشروعها. النظام القديم تراجع شكلياً، ثم عاد بمنطق لغوي جديد. فقد التمرّد مركزه، لأن اللغة نفسها فقدت ثباتها. لم يُعَد إنتاج الحقل الرمزي. بقيت القيم على حالها، والمفاهيم لم تُمسّ، والمخيلة لم تتغير. ما تغيّر هو ترتيب الصور. صار بالإمكان أن يُقال “كرامة” داخل خطاب ينتهكها، وأن يُقال “شعب” داخل جهاز يُقصيه. فقد المعنى صلابته، وأصبحت اللغة ميدان صراع لا ينتج دلالة مستقرّة. المجتمع الذي يعيش في ظل هذا التفكك لا يستطيع أن يُعيد لملمة تجربته. لا يملك سردية كبرى، ولا سرديات جزئية قادرة على التفاوض. كل شيء مبعثر. كل صوت يشكّك في الصوت الآخر. ينقض كل معنى المعنى الذي سبقه. لا توجد ذاكرة جمعية، بل أرشيف متضارب. لا يوجد مركز، بل مواقع متنازعة. كل موقع ينتج حقيقة، وكل حقيقة تُستبدل بأخرى خلال أيام.
غياب السردية لا يعني فقط غياب النظام، وإنما انهيار الفضاء العام بوصفه ساحة للاعتراف. حين يفقد الخطاب قدرته على تمثيل الذات، تختلّ العلاقة بين القول والفعل. الكلمات تُستعمل من الجميع، لكنها لا تعني الشيء نفسه لأحد. يُعاد ترديد الشعار، لكنه لا يقود إلى فعلٍ محدّد. يُقال “حرية”، من دون أن يعرف أحدٌ لمن هي، وكيف تُقاس، وأين تبدأ أو تنتهي. في هذا التشظي، لا تستطيع الجماعة أن تؤسّس لنفسها موقعاً تاريخيّاً. تمرّ اللحظة الثورية وتنقضي، من دون أن تنتمي إلى زمن محدد ومن دون أن تُفسَّر. هذا هو التمرّد في زمن ما بعد السردية: فعل بلا ماضٍ، ولا مستقبل. كثافة في الظهور، وفراغ في التفسير.
استطاعت الأنظمة التي استوعبت هذا التفكك أن تُعيد بناء سلطتها، لا من خلال القمع وحده، وإنما من خلال السيطرة على نظام التمثيل. لم تعد مضطرّة إلى منع الخطاب، اكتفت بتفريغه. أفسحت المجال أمام كل الأصوات كي تتكلّم، ثم نزعت من الكلمات معناها. صارت الثورة مجازاً في احتفال رسمي، وصار الشعار زينة لغوية في خطاب بيروقراطي. المجتمعات التي لا تملك أدوات السرد تُهزم في ميدان المعنى، حتى لو انتصرت فجأة؛ لحظة سقط أمامها النظام الذي ثارت عليه.