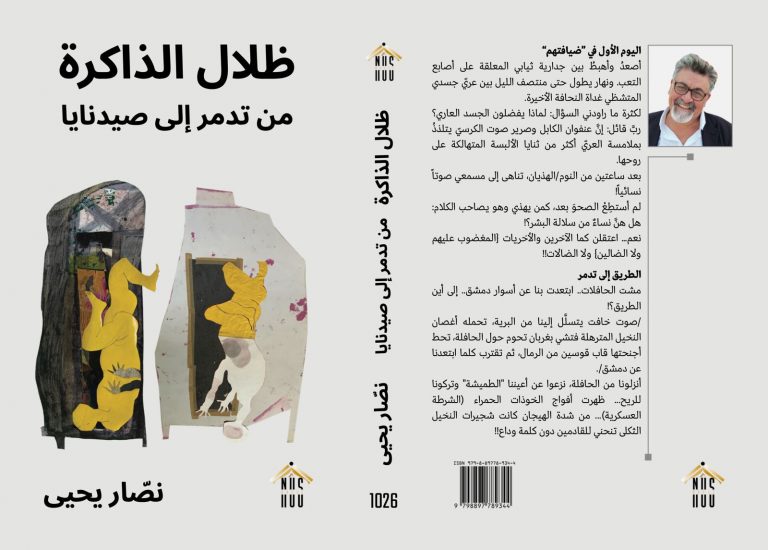ملخص
تتناول المتتالية القصصية “أغنية الوالي” للكاتب المصري محمد أبوالنجا، صراع الفن والسلطة، عبر 4 قصص تدور حول شاعر وملحن ومغنية وقائد حرس، تكشف كيف يقمع الفن ويوظف في خدمة الاستبداد.
تجاري المتتالية القصصية أغنية الوالي” (بيت الحكمة – القاهرة) للكاتب المصري محمد أبوالنجا، في فكرتها الرئيسة ما طرحه أفلاطون في كتابه “الجمهورية”، بخصوص ضرورة طرد الشعراء من المدينة الفاضلة، لتجنب قدرتهم على قلب الأوضاع رأساً على عقب، بتأثيرهم الوجداني. فالشعر عنده مهيج للانفعالات، الضحك، الشهوة، الغضب، والرغبة، ويغذي اللذة بدلاً من كبحها، لذا فإن نفي الشعراء ضرورة، في نظره، لتجنب غوايتهم للناس.
وهو ما يمارسه “الوالي” في المتتالية المؤلفة من أربعة فصول، يتناول كل منها علاقة نوع فني بالسلطة: “قصيدة الوالي”، “لحن الوالي”، “صوت الوالي”، و”إيقاع الوالي”. القصة الأولى تسرد حكاية شاعر بدأ حياته يكتب عن الحب والطبيعة، قبل أن يتحول إلى صوت الناس، يعبر عن أوجاعهم، وينقل آمالهم وطموحاتهم، ويستنهض فيهم روح التمرد والثورة. وبعد أن أخذ الناس يرددون شعره في كل مكان، يتحول ذلك الشاعر إلى النموذج الذي حذر منه أفلاطون، حين قال “نحن مستعدون للاعتراف بأن هوميروس هو أعظم الشعراء، وطليعة كتاب التراجيديا، غير أننا يجب أن نظل ثابتين على اعتقادنا بأن الأناشيد الدينية للآلهة، ومدائح مشاهير الرجال هي الشعر الوحيد المسموح به بقبوله في دولتنا، لأننا إذا تعدينا هذا الحد وسمحنا بدخول عروس الشعر المعسول سواء في الملاحم أو الشعر الغنائي، فحينئذ تحكم دولتنا اللذات والآلام بدلاً من القانون والعقل البشري الذي تقرر بالإجماع أنه خير الأمور”.
الجزيرة السجن
هذا الشاعر، تجاوز القدر المسموح به من الشعر، فأرسله الوالي، إلى سجن في جزيرة غير مأهولة، لينضم إلى آخرين، قبل أن يفر حراسهم بعدما لمحوا أسطول الأعداء يقترب من حدود الدولة. وهكذا مات ذلك الشاعر مع باقي المساجين جوعاً، وباتت عظامهم، شاهداً على بشاعة القمع.
أما بطل القصة التالية، فهو موسيقي صاحب قدرات خارقة فتنت الناس، أعجب به الوالي إلى درجة أنه أعطاه قصر وزيره الذي يضاهي قصره فخامة وأبهة لا لشيء سوى أنه قد قدم لحناً في مديحه كان الناس يرددونه في الأسواق وفي منازلهم. لكن ينتهي الحال بهذا الملحن وحيداً تطارده الهلاوس في قصره الفاره الذي اختار أن يسجن ذاته فيه. وتحكي القصة الثالثة، عن مغنية تمردت على قانون الوالي الذي يفرض على الناس ألا يتحدثوا إلا بكلمة واحدة. لكنها اخترعت أسلوباً جديداً في الغناء يسمى “التصدية”، تمكنت من خلاله من كسر هذا الحصار اللغوي المفروض حتى على الأطفال. أسرت المغنية الجمهور بصوتها الفريد، فأقبل الناس من كل حدب وصوب للاستماع إليها. وسرعان ما أدرك الوالي شعبيتها، فسمح لها بالغناء بحرية، لكنه جعل صوتها وسيلة لإعادة الهيبة إلى سلطته. وهنا خشي الملحن أن يفقد مكانته لدى الوالي، فقرر التعاون معها، بألحان تناسب أسلوبها المتفرد. وهكذا أصبحا معاً حديث الناس، الذين راحوا يتجمعون كل ليلة أمام منزلها، وصنعوا لها كرسياً فخماً تغني وهي جالسة عليه. طلبوا منها أن تغني عن أوجاعهم، لكنها لم تكن تختار إلا ما يعجبها، وكان جمال صوتها يغطي على ضعف الأشعار التي تؤديها. فتنت المغنية بنفسها، وبحب الناس المفرط لها، ومع تصاعد نرجسيتها، اعتقدت أن لها طبيعة مفارقة للبشر، فتبرأت من إخوتها الذين يتجاوز عددهم الـ40، وانسحبت إلى كهف في الصحراء حيث اختارت العزلة الكاملة، وماتت هناك، وحيدة، في نهاية تشبه مصير الملحن الذي سبقها إلى الموت وسط عزلته الاختيارية.
الفن والسلطة
thumbnail_محمد أبو النجا (صفحة فيسبوك).jpg
محمد أبو النجا (صفحة فيسبوك)
في القصص الثلاث، ترسم المتتالية صورة مركبة لعلاقة الفن بالسلطة، كاشفة كيف يمكن أن ينقلب مجد الفنان إلى سقوط مدو. هذا ما يرصده “جعفر العدوي”، قائد الحرس، وهو يتأمل مصائر الشاعر والملحن والمغنية، مشيراً إلى الفارق الجوهري في اختياراتهم. فجميعهم، في نهاية المطاف، اختاروا العزلة، إما قسراً كما حدث مع الشاعر، الذي نفي إلى جزيرة نائية، أو طوعاً، بعدما فقد الملحن والمغنية الإحساس بالمعنى، وانغلقا على نفسيهما، غارقين في نرجسية قادتهما إلى نهاية مأسوية.
ويرى العدوي أن الفارق الأخلاقي بين الشاعر من جهة، والملحن والمغنية من جهة أخرى يكمن في موقعهم من الناس، فبينما ظل الشاعر وفياً لآلامهم وأحلامهم، قدم الآخران فنهما خدمة للوالي، ومن ثم شاركا في تضليل الوعي الجماعي.
تدور القصة الرابعة والأخيرة من المتتالية حول قائد الحرس “جعفر العدوي”، الذي يضبط إيقاع دولة الوالي بقوته العسكرية وحكمه للناس بالحديد والنار. فإيقاع الوالي، الذي يشير إليه عنوان القصة، مقصود به وقع خطوات الجنود، فأي خلل فيها يعني خللاً في نظام المملكة ككل. هذا الإيقاع الذي يرفض أن يشاركه أي إيقاع آخر، لذا رأى الوالي وقائد حرسه في إيقاعات الشاعر المتعددة خطراً يمس هيبة المملكة. وهو أمر لم يكن يدركه قائد الحرس حين كان مجرد جندي بسيط في سجن الجزيرة النائية، منبوذاً من الجميع، يوكل إليه جمع فضلات السجناء. وفي هذه الفترة، وجد بعض السلوى في أحاديثه مع الشاعر، الذي كان يؤنس وحدته. وعندما حاول ذات يوم أن يعتذر لقائده عن خطأ ما، استعان ببيت من الشعر. لكن القائد رد عليه بعنف، وسجنه، وعرضه للتنكيل، من دون أن يفهم السبب.
تمويه الخطاب
بعد 33 عاماً، يعود العدوي إلى الجزيرة نفسها، ولكن هذه المرة بوصفه قائداً للحرس. وهناك فحسب، يفهم سر حبسه لمجرد ترديده بيت شعر، ويدرك الغاية من بناء ذلك السجن، “فالفنون التي لها السطوة على العوام تسوقهم إلى الفوضى ثم هلاك البلاد” ص157.
“فانتازيا” السرد السوداوي في مجموعة قصصية مصرية
مقبول العلوي يخوض قصصيا “تدريبات شاقة على الاستغناء”
هذا السجن، الذي عاد إليه العدوي بعد ثلاثة عقود، لا يغلق أبوابه حتى حين يفرغ من نزلائه. فخوفاً من أن يتوقف عن العمل، أعاد العدوي ملأه مجدداً، لكن هذه المرة بجنوده أنفسهم، متهماً إياهم بمخالفة قانون الولاية والسخرية من الحاكم الأعرج.
وهنا تكشف المتتالية طبيعة السلطة التي حين تفرغ من أعدائها الحقيقيين، تبدأ في اختراع أعداء وهميين لإطالة أمد وجودها، وتبرير قمعها، والحفاظ على شرعيتها. فالسجن لا يبنى فقط لحبس الخارجين على النظام، بل لحماية النظام من فراغه، من انكشاف هشاشته. كما أن العدوي يرى أن نهاية السجن نهاية له هو شخصياً، ومن ثم فإنه يحرص كل الحرص على ألا يغلق أبوابه حتى ولو لم يبق في الجزيرة سواه ليموت وحيداً كما مات المسجونون من قبل.
ويلاحظ في المتتالية القصصية غياب شخصية “الوالي” بوصفه شخصية فاعلة أو حاضرة في مشهد السرد. فلا يظهر الوالي بشحمه ولحمه بشكل فعال في أي من القصص، وإنما يتم استبدال حضوره الفعلي بحضور نائبه وقائد حرسه، “جعفر بن العدوي”، الذي يمثل وجه السلطة التنفيذية، وذراعها التي تبطش بها. ويلاحظ كذلك أن المتتالية أشارت مراراً إلى أن هؤلاء الجنود لا يملكون صوتاً خاصاً بهم، بل هم مجرد صدى لصوت الحاكم، وأداة لفرض سلطته، “لا نملك صوتاً، ولو اعتقد الناس عكس ذلك” ص89. فالصوت، والسوط، والسلطة “ثلاثية الحكم” لا تقوم إلا بوجودهم، ومن دونهم لا يكون للوالي وجود يذكر.
استثمر محمد أبوالنجا أسلوب الحكايات الشعبية في المتتالية القصصية كقناع يموه به خطابه السياسي، ليبعد عنه المباشرة في طرح قضاياه. كما لم يحدد زماناً أو مكاناً للأحداث، مما يمنحها صفة العمومية والكونية، ليصبح خطاباً ينطبق على كل زمان ومكان، حيث تعسف السلطات بالشعوب عبر فرض قوانين جائرة تقمع الكلام وتقضي على أي معارضة، رافعة شعار “لكل إنجاز ضحاياه”.