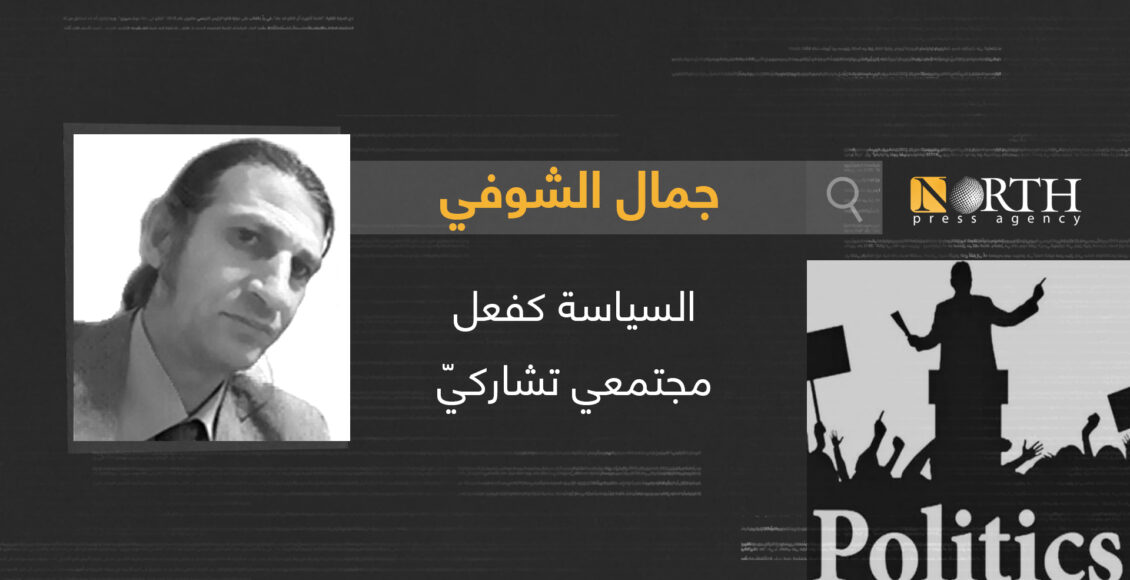لطالما بقي سؤال “التأخر السياسي” في المجتمعات العربية عامة والسورية خاصة، قيد فرضيات متعددة، تجيب كل فرضية منها على إحدى جوانبه دون بقية الجوانب، بحيث تبدو بعض الإجابات قاطعة جازمة وكأنها قانون علمي كالجاذبية مثلاً. فالقول بتخلف المجتمع العربي، والتربية، والانحطاط العام الذي أصاب المجتمع ووصفه بعصر الظلمات في أوروبا… جميعها أجوبة سهلة التناول وأدلتها كثيرة. لكن، هل يمكن لسؤال هذه الفرضية أن يجيب عن تحول أوروبا من عصر الظلمات لعصر الأنوار؟ وهل يمكنه أن يجيب عن بواكير الربيع العربي عام 2011؟ وهل يجيب عن استمرار مظاهرات السويداء لتسعين يوماً متتالياً؟
في المقابل ثمة إجابات هي أسئلة بحد ذاتها؛ فالقول بأن “السياسة فن الممكن”، أو فن إدارة المجتمع، أو ممارسة الأخلاق والفكر… أسئلة فكرية بحد ذاتها تلقي الضوء على المشكلة، ولا تحدد مستويات متغيراتها بين لحظة وأخرى؛ فزعيم القبيلة يدير قبيلته وفق الممكن، وضمن القيم الأخلاقية الموروثة، ورئيس دولة عصرية يمارس ذات الفعل في المعنى والمضمون، وكلاهما فعل سياسي رغم اختلاف المستويات الزمنية بين كليهما. لكن في الحالين لا يمكن تشخيص السياسة المرهقة التي نعيشها في مجتمعاتنا.
هي محاولة تستحق المجازفة للنفوذ بين شطري المعضلة، سواء كانت إجابات قطعية، أو أسئلة معرفية لا تحدد الفوارق والحدود. ففي افتراض يدعي العقلانية والواقعية: لنعتبر أن القائم والموجود من سياسات وممارسات حزبية، سلطوية أو معارضة، قومية أو ماركسية أو علمانية أو إسلامية، قائمة بالواقع فعلياً، وهذا تحديد أولي يقر بها جميعاً ولا ينفي أي منها. فيما اكتمال الوجه الآخر بوصف هذه التيارات مشتركة سواء في جبهة وطنية تتبع للنظام، أو تحالفٍ لقوى معارضة مقابلة، وكلاهما غير قادر على حل مشكلات المجتمع، والوصول تالياً لحل سياسي لكارثته، رغم ممارستها فن الممكن وإدارة مجتمعها الضيق أو المفترض أنها تمثله، الأمر الذي يقود للفرضية التي تقول: السياسة لليوم في سوريا، والمنطقة العربية عموماً، هي فكر نظري لم يُمارس في الواقع ولم تًختبر قدرته على أن يكون فعلاً مجتمعياً، إذ إن سلطات المنطقة مارست فعل التسلط والقوة واحتكار السلطة ومنع المختلفين من مشاركتها حتى في الرأي! فأقامت السجون والمعتقلات ومجازر تدمر وصيدنايا وكل أفرع المخابرات، لا بل وأقامت مجزرة على قياس وطنٍ بأكمله، فيما لم تتمكن قوى المعارضة السورية من تبني حالة توافقية، أو ديمقراطية، تثبت من خلالها قدرتها على الاختلاف والتماسك في آن، بحيث أن الاختلاف لا يعني الخلاف والقطيعة، والتماسك لا يعني الانصهار في بوتقة واحدة. ومن هذه النقطة بالذات تبدو دلالات المشكلة المتأزمة في أيديولوجياتنا السياسية وطرق ممارستها ومدى مسؤوليتها عن استمرار الكارثة التي نعيش.
الأوربيون، الذين نحلم بأن نكون مثلهم، لم تولد السياسة العصرية عندهم دفعة واحدة؛ فقد تدرجت وفق مستويات متعددة يمكن صياغة خلاصاتها بمراحل متعاقبة. فبدءاً من الحكم المدني لجون لوك الذي أطلق من خلاله الحد الفارق بين المجتمع الأهلي القائم على القيادة الجمعية للرعايا، إلى الوصول للمجتمع المدني والحريات الفردية المطلقة، وهو المضمون الذي أخذته عنه أميركا الحديثة في دستورها العصري، وأضافت عليه حق الدفاع عن النفس وحمل السلاح الفردي ضمن القانون وبصيانة الدستور. في حين كان لتوماس هوبز فرضية أخرى تذهب ناحية البحث عن الاستقرار والأمان إبان الثورة الإنكليزية حيث سيجرب البشر أفكارهم في الواقع حتى يكتشفوا بيديهم صوابها من خطئها، وكان أن أخذت بريطانيا أفكاره أساساً لدستورها العرفيّ بعد أن عاشت فوضى التجارب لتكتشف معنى الاستقرار في دولة حديثة. أما جان جاك روسو فكانت له الميزة الأكثر إثارة في الفكر السياسي حين جمع بين الحرية الفردية، والتجربة الواقعية، بالإرادة الحرة وبالتنازل عن بعض من مكتسبات الحرية الفردية وعدم الوقوع في تجارب الواقع المريرة وصراع شرعية الأفكار السياسية، ما قاده لفرضية “التعاقد الطوعي” وتنازل الجميع لبعضهم في سبيل “الإرادة العمومية” والتي تشكل الهوية العمومية للمجتمع، فهذه الإرادة لا تقمع حرية الفرد، ولا تلغي التجربة، بل تجمع كليهما في مصلحة عامة وهوية عمومية أسماها “العقد الاجتماعي”. ومنها انتقلت الدولة الفرنسية للحداثة بعد طول ثورة استمرت في تقلباتها عشرات السنين.
السياسة كفعل مجتمعي يجمع بين الحرية والتجربة والمصلحة العامة، والتي تلتقي جميعها في مفاهيم العقد الاجتماعي ليس وحدها ما ينقص مجتمعاتنا سياسياً وحسب، بل القدرة على جمع هذه المفاهيم معاً في إطار عام. والإقرار بأن ما نمارسه من سياسة لليوم هو إما موروث قبلي سلطوي لا يملك سوى لغة الإرادة العٌلوية المفروضة، أو فكرٍ نظري يتحارب على أحقية فرضيات وأيدولوجيات تبرر حجة فريق دون الآخر، ولم تُختبر أحقية أي منها في الواقع إلى ليوم، فيما القول السائد أن حقبة الاستبداد هي التي قادتنا لهذه الكارثة غير كافٍ لتحويل مسار الهدم والكوارث التي نعيشها دون أن نحاول في مجال العمل السياسي من بوابات مختلفة.
السياسة كفعل مجتمعي أيضاً تفترض الممارسة والتجربة، فإلى جانب الحرية والكرامة، والمصلحة المجتمعية العامة، لا يمكن افتراض إحدى نماذج السياسات التسلطية التي تفرض هيمنتها على الآخرين بأنها صالحة لتحقيق المثلث أعلاه. فيما طوعية التعاقد وفق الأسس الأخلاقية ناقصة الاكتمال وفق المعطيات الواقعية رغم أهمية طرحها، وما تعنّت سلطات الأمر الواقع السورية بما فيها سلطة النظام إلى اليوم سوى دليل فاقع على فشلها. فيما البحث عن التشارك بالفعل المجتمعي وآليات إنتاج التوافق عل المصلحة العامة، أظنه يتفق مع قيم وأفكار عصر الأنوار الذي أنتج الدول العصرية. ويضيف عليها فارقاً نوعياً متمثلاً بالروح الشرقية القادرة على الاحتواء والتعاطف والتكاتف. فإذا ما استثنينا سلطات العسكر المستبدة، أصل كوارثنا، التي نرزح تحت وقع جبروتها وتسلطها، وتوجهنا لصنوف المعارضة السورية وحوامل فعلها المجتمعي وطرحنا على أنفسنا الأسئلة المتكررة: هل تكفي الحرية بمفردها، وهل تكفي نظرية بمفردها، وهل تكفي مصلحة فريق أو قوم أو جماعة بمفردها؟ وهل يكفي تبرئة ذمتنا بأننا كنا أسرى نظم الاستبداد؟ وأعيد طرح السؤال هل يمكن أن نجرب عن وعي وإرادة حرة الفعل التشاركي والتوافق الطوعي على تجاوز أيديولوجياتنا ومصالحنا الضيقة وأفكارنا المسبقة، والتمتع بكامل الأهلية والجدارة والاستحقاق أمام تضحيات هذا الشعب منذ 13 عاماً؟
الحرية والتغيير جملة سياسية نشطة تجمع توافقياً بين المكنون الوجودي للفرد وحقه في الاختيار، وبين معطيات الواقع السياسية التي تستلزم التشاركية في الفعل السياسي، وتعيد إنتاجه من منطلق الفعل الاجتماعي حيث يمكّن تجربة الحرية والتعددية السياسية والمدنية والأهلية بآن. وهل يمكن البحث في سؤال السياسة كفعل مجتمعي تشاركي، ونراقب بشغف مروره بين الكل السوري مفترضاً إمكانية تفعيل التغيير السياسي الوطني كمصلحة سورية عامة، بشرط أن تكون الحرية في التعاقد التوافقي على دولة لكل السوريين؟ أظن ما سبق هو أضعف الإيمان.